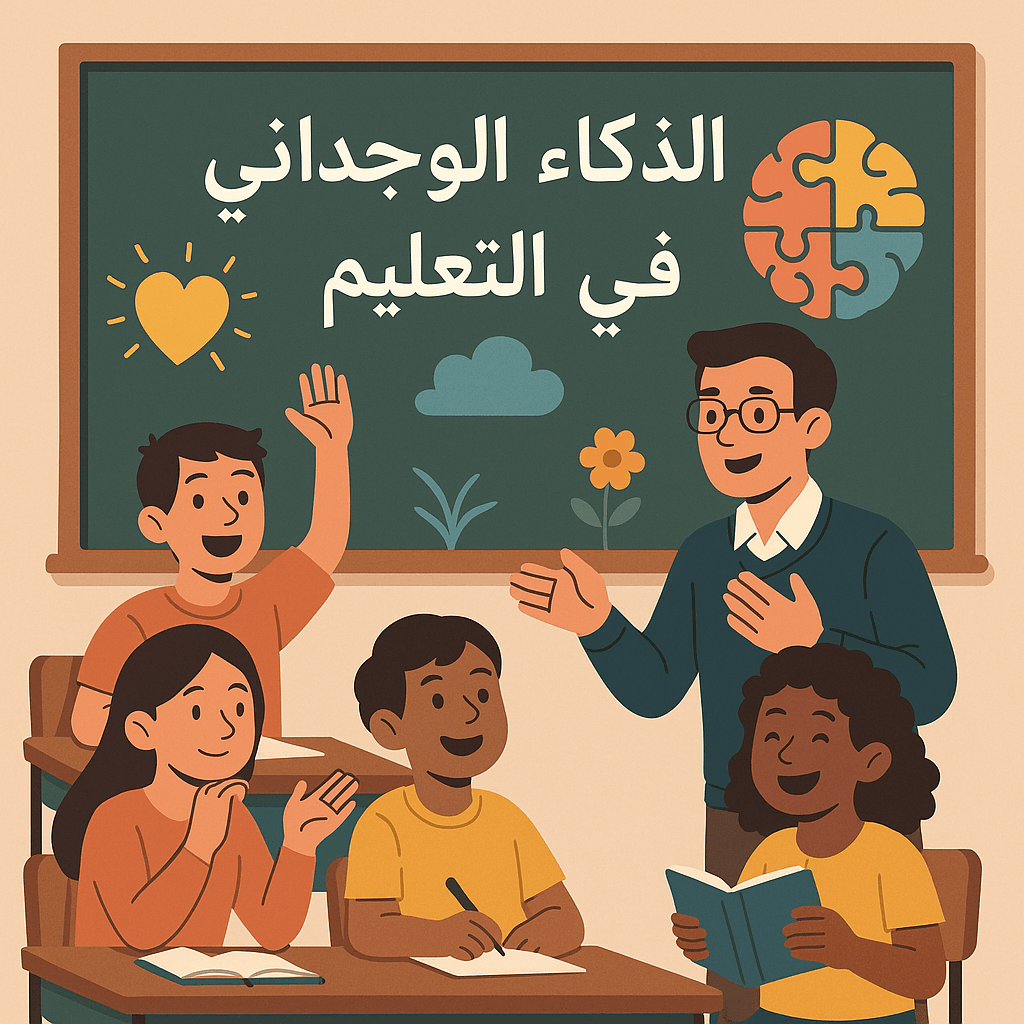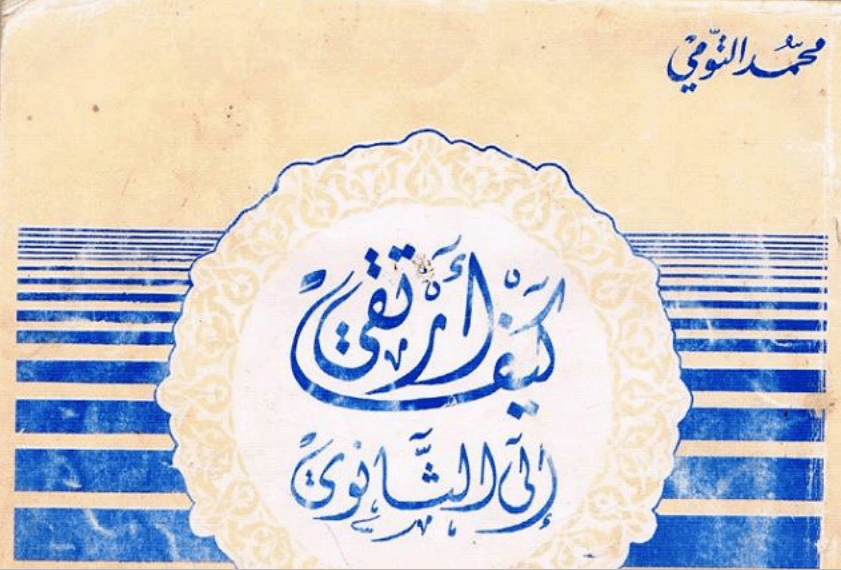نحو مدرسة القيم: تصور لإدماج التربية على القيم كمجال أفقي إجباري في المنظومة التربوية التونسية

Contents
نحو مدرسة القيم: تصور لإدماج التربية على القيم كمجال أفقي إجباري في المنظومة التربوية التونسية
هذا المقال بقلم الأستاذ الخبير في الشأن التربوي عماد إيلاهي
مقدمة
تشكل التربية على القيم إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها النظم التربوية الحديثة، لما لها من دور محوري في بناء شخصية المتعلم المتكاملة، وتنمية قدراته على التفاعل الإيجابي مع محيطه الاجتماعي والثقافي. ففي ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة، أصبحت المدرسة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتجاوز وظيفة التلقين المعرفي الضيق، والانخراط الفعلي في بناء الإنسان المواطن، القادر على التمييز، والتسامح، والمشاركة، والانفتاح على الآخر.
في السياق التونسي، برزت في السنوات الأخيرة تحديات متنامية تؤثر سلبًا على المناخ المدرسي والاجتماعي، من قبيل العنف المدرسي، وانتشار خطابات التطرف والتمييز، وضعف الشعور بالانتماء لدى عدد من المتعلمين، فضلًا عن الانفصال بين التعلمات المدرسية وحياة المتعلم الواقعية. وقد كشفت هذه الإشكالات عن محدودية المقاربات التربوية التقليدية، وخاصة ما يتعلق بتناول القيم كمجرد مضامين ظرفية في بعض المواد، لا كتوجه استراتيجي شامل ومندمج في التجربة التربوية اليومية.

من هذا المنطلق، يطرح المقال الإشكالية التالية: كيف يمكن الانتقال من تناول التربية على القيم كدرس مناسباتي محدود، إلى اعتمادها كمجال أفقي إجباري، مدمج في جميع المواد والأنشطة المدرسية؟
ويهدف هذا العمل إلى:
- إبراز أهمية التربية القيمية في السياق التربوي الراهن.
- تشخيص وضعها الحالي في المدرسة التونسية.
- اقتراح تصور إدماجي أفقي قابل للتنزيل العملي.
- تقديم آليات تنفيذ وتقييم فعّالة لضمان نجاعتها واستدامتها.
I. الإطار النظري والمفاهيمي
1. مفهوم التربية على القيم
تُعد التربية على القيم مسارًا تربويًا يهدف إلى غرس منظومة من المبادئ والمعايير الأخلاقية والاجتماعية في سلوك المتعلمين، بما يُمكّنهم من التصرّف بشكل مسؤول، ومتوازن، ومُنفتح في محيطهم الأسري والمدرسي والمجتمعي. وتُبنى التربية القيمية على ثلاث أبعاد متكاملة:
بُعد معرفي: يتيح للمتعلم فهم القيم واستيعاب دلالاتها ومعانيها النظرية.
بُعد سلوكي: يعكس قدرة المتعلم على تجسيد القيم في ممارساته اليومية؛
بُعد وجداني: يُعبّر عن قناعة داخلية وميول شخصية نحو تبنّي تلك القيم والالتزام بها.
ويختلف مفهوم التربية على القيم عن مجرد التعليم الأخلاقي؛ إذ لا يقتصر الأول على تقديم مضامين أخلاقية جاهزة، بل يُشجع على النقاش، والاختيار، والمساءلة، والممارسة التفاعلية، مما يجعله أكثر عمقًا وارتباطًا بالحياة اليومية للمتعلمين.
2. أنواع القيم المستهدفة
تُعنى التربية على القيم بجملة من المبادئ التي تُشكّل مرجعية سلوكية ومجتمعية، من أبرزها:
- قيم المواطنة: الانتماء، احترام القانون، المشاركة الفعّالة، التضامن.
- حقوق الإنسان: المساواة، الكرامة، الحريات الفردية والجماعية.
- الاحترام والتسامح: قبول الآخر، الحوار، التعايش السلمي.
- القيم البيئية: المحافظة على الطبيعة، ترشيد الموارد، السلوك الإيكولوجي.
- قيم العمل: الجِد، المسؤولية، الإتقان، المبادرة.
- القيم الاجتماعية: التعاون، الإنصاف، المساعدة، التعاطف.
ويتم اختيار هذه القيم انطلاقًا من حاجات المجتمع التونسي وتطلعاته إلى إرساء ثقافة ديمقراطية مدنية حديثة، قادرة على التصدّي للتحديات القيمية الراهنة.

3. المرجعيات التربوية المعتمدة
تستند التربية على القيم في تونس إلى جملة من المرجعيات الرسمية والمعنوية، لعلّ أبرزها:
البرامج الرسمية التونسية: التي تتضمن كفايات قيمية عرضية وأهدافًا سلوكية متعلقة بالهوية، والانفتاح، والمواطنة، لكنها لا تزال تفتقر إلى إدماج أفقي فعلي ومُمأسس.
الدستور التونسي : الذي ينص في ديباجته وفصوله على حقوق الإنسان، الحريات، كرامة المواطن، والعدالة الاجتماعية؛
الاتفاقيات الدولية: كاتفاقية حقوق الطفل، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإتفاقيات البيئية، التي صادقت عليها الدولة التونسية؛
II. الوضع الحالي للتربية على القيم في المدرسة التونسية
رغم الوعي المتزايد بأهمية التربية على القيم داخل الأوساط التربوية في تونس، فإن حضورها ضمن المنهاج التعليمي الرسمي لا يزال مشتّتًا وغير ممنهج، مما يُقلل من فاعليتها في بناء سلوك المتعلم وتوجيهه نحو اختيارات واعية ومسؤولة.
1. مظاهر حضور القيم في البرامج والمواد الدراسية
تتجلّى القيم بدرجات متفاوتة ضمن بعض المواد الدراسية التقليدية، نذكر منها على وجه الخصوص:
- مادة التربية المدنية: تتناول موضوعات تتعلق بالحقوق والواجبات، مؤسسات الدولة، قيم المشاركة والانتماء؛
- مادة التربية الإسلامية: تتضمن مفاهيم أخلاقية وسلوكية مثل الصدق، الأمانة، التعاون، احترام الغير؛
- مادة التاريخ: تبرز من خلالها قيم مثل الهوية، المقاومة، الانتماء الوطني؛
- بعض الأنشطة الثقافية والفنية: تُمكّن من التعبير عن قيم الجمال، الحوار، والإبداع.
ورغم هذا الحضور الجزئي، فإن التربية على القيم تبقى محصورة في مجالات معرفية محدودة، ولا تحظى بالتكامل المطلوب مع بقية المواد التعليمية.

2. ملاحظات نقدية على الممارسة الحالية
يعاني إدراج القيم في المنظومة التربوية التونسية من عدد من الإشكالات البنيوية والبيداغوجية، يمكن تلخيصها فيما يلي:
- الطابع النظري المجرد: تُقدَّم القيم غالبًا في شكل مفاهيم نظرية معزولة عن الواقع الحياتي للمتعلم، مما يُضعف تمثلها وتمثل آثارها السلوكية.
- الأسلوب التلقيني: تُعرض المضامين القيمية بطريقة تقليدية، ترتكز على الحفظ والإلقاء، دون فسح المجال للنقاش أو التجريب أو المواقف التفاعلية.
- غياب التقييم الفعلي: لا توجد أدوات منهجية لقياس مدى تمثل المتعلم للقيم أو تحوّلها إلى سلوك واقعي، كما لا يتم رصد تطورها بشكل دوري.
- انعدام الوحدة البيداغوجية: يُلاحظ غياب التنسيق الأفقي والعمودي بين المواد، مما يؤدي إلى تكرار المحتوى في بعض الأحيان، أو تضاربه، أو تجاهله في مواد أخرى، بما يحول دون تحقيق التكامل المطلوب لبناء تصور قيمي موحد ومترابط.
III. التصور المقترح للإدماج الأفقي للتربية على القيم
في ضوء التحديات المرتبطة بالحضور الضعيف والتقليدي للقيم داخل المنظومة التربوية، يبرز خيار الإدماج الأفقي كمنهج بديل وفعّال يُمكّن من إرساء تربية قيمية مُندمجة، تعبر كل مجالات التعلم، وتُفعّل في مختلف المواد الدراسية والأنشطة التربوية.
1. المفهوم: الإدماج الأفقي للقيم
يقوم الإدماج الأفقي على مبدأ توزيع القيم ومضامينها عبر المواد الدراسية المتنوعة، بحيث لا تبقى حكرًا على مواد بعينها، بل تصبح مكوِّنًا قارًّا ومندمجًا في كل مجال معرفي. ففي مادة اللغة العربية مثلًا، يمكن إدراج نصوص أدبية تعالج قضايا التسامح واحترام الآخر، وفي مادة العلوم تُطرح قضايا بيئية تُنمّي حس المسؤولية تجاه الطبيعة، أما في الرياضيات، فيمكن تصميم تمارين تُبرز مفاهيم العدل والمساواة عبر المسائل الحياتية.
وتنسحب هذه المقاربة على مواد مثل الفرنسية، التربية التشكيلية، التكنولوجيا، والتربية البدنية، لتصبح القيم بُعدًا قارًا في جميع الوضعيات التعليمية، مهما اختلف محتواها أو طبيعتها.

2. آليات الإدماج المقترحة
لتحقيق هذا الإدماج، يمكن اعتماد آليات بيداغوجية متعددة ومرنة، منها:
- الوحدات التطبيقية: حيث تُخصص حصة أو أكثر لصياغة وضعيات تعليمية دامجة لقيمة معيّنة، ترتبط بالواقع المعيش للمتعلمين.
- الدروس الدامجة: وهي دروس عادية مبرمجة في الجدول الزمني، لكن تُضَمن فيها قيم محددة ضمن المحتوى أو الأنشطة أو التقييم.
- المشاريع بين المواد (Interdisciplinary Projects): يُنجز المتعلمون مشاريع تعليمية تدمج معارف من أكثر من مادة، وتدور حول قيمة مركزية (مثل التضامن أو المواطنة).
- الأنشطة الميدانية: مثل حملات نظافة، أيام تحسيسية، أو زيارات ميدانية لمؤسسات اجتماعية، تهدف إلى تنمية القيم عبر التجربة المباشرة.
ويمكن أيضًا اعتماد أداة تنظيمية مبتكرة تتمثل في دفتر “القيمة الشهرية” أو “دفتر القيم المندمجة”، يوثق فيه المتعلم التقدم الذي أحرزه في استيعاب قيمة معينة عبر أنشطة مختلفة، مع فسح المجال للتأمل الذاتي والتقييم التكويني.

ولتحقيق ذلك، من الضروري:
3. دور الإطار التربوي
يلعب الإطار التربوي، وخاصة المدرّس، دورًا محوريًا في إنجاح التربية على القيم. فهو لا يُعد مجرد ناقل للمعرفة، بل فاعل قيمي يُجسّد القيم في سلوكاته، ويُوجّه المتعلمين نحو تبنّيها.
- دعم المدرّسين عبر برامج تكوين مستمر متخصصة في بيداغوجيا القيم، تشمل استراتيجيات إدماجها في التدريس، والتقييم السلوكي، والتعامل مع التنوع القيمي داخل القسم؛
- تعزيز ثقافة الحوار والنموذج الإيجابي داخل فضاء المدرسة؛
- تمكين المدرّس من أدوات تقييم ملائمة للقيم تُراعي السياق السلوكي والنفسي للمتعلمين.
4. دور الأسرة والمجتمع
لا يمكن للتربية على القيم أن تنجح بمعزل عن محيط المتعلم، لذا يُعدّ انفتاح المدرسة على الأسرة والمجتمع المدني ركيزة أساسية لترسيخ المنظومة القيمية، عبر:
- شراكات فعالة مع الجمعيات الثقافية والبيئية والحقوقية.
- حملات توعوية مشتركة تعزز تواصل المدرسة مع أولياء الأمور.
- تنظيم أنشطة مدرسية مفتوحة (أيام قيم، أسابيع مواطنة، لقاءات حوارية…) يُشارك فيها المتعلمون وأولياؤهم والمجتمع المحلي.
يمثّل هذا التصور المقترح نواة مشروع وطني شامل، يُرسي ثقافة مدرسية قائمة على المعنى والانخراط، ويسهم في تربية أجيال متزنة، واعية، ومنفتحة على قيم العصر.
IV. مقترحات عملية للتطبيق
من أجل تنزيل فعلي وميداني للتصور الإدماجي للتربية على القيم داخل المدرسة التونسية، لا بد من ترجمة المبادئ النظرية إلى أدوات بيداغوجية مرنة، واقعية، ومتكاملة مع المحتوى التعليمي اليومي. ويقترح هذا القسم جملة من المبادرات العملية القابلة للتكييف حسب السياقات المدرسية المختلفة
1. أمثلة على دمج القيم في بعض الدروس
يتطلب إدماج القيم اعتماد منهجية تربوية تقوم على الربط بين المضمون المعرفي والقيم الإنسانية. فيما يلي بعض الأمثلة التطبيقية:
- في اللغة العربية: يمكن تقديم نص حواري يدور حول قضية الخلاف في الرأي، ويُستثمر في مناقشة قيم الاختلاف والتسامح وحرية التعبير. يُكلف المتعلمون بإعادة كتابة الحوار بشكل يحترم آداب النقاش، مما يُنمّي مهارات الإصغاء والتعبير القيمي.
- في مادة العلوم: يُمكن اقتراح مشروع جماعي حول التلوث، تتم فيه دراسة أسبابه وتأثيراته، واقتراح حلول ميدانية من قِبل المتعلمين، مما يُعزز قيم المسؤولية البيئية، المبادرة، والتعاون.
- في مادة الرياضيات: تُوظف مسائل حياتية تتناول توزيع الموارد أو الميزانيات بطريقة عادلة بين فئات أو أشخاص، مما يُساعد على غرس قيم العدالة والإنصاف والتفكير النقدي.
تتمثل القيمة المضافة في هذه الممارسات في تحويل الدرس من لحظة معرفية إلى تجربة حياتية تُكسب المتعلم معنىً جديدًا للتعلّم.
2. إنشاء “شبكة القيم المدرسية”
تقترح هذه المبادرة تطوير نظام تتبع داخلي يُرصد من خلاله تطوّر تمثل المتعلم للقيم، عبر أدوات كمية ونوعية:
- سجل تربوي شخصي يُدوّن فيه المدرّسون ملاحظاتهم حول سلوك المتعلم القيمي في القسم (احترام، تعاون، مسؤولية…).
- بطاقة متابعة شهرية تتضمن قيمًا محددة، يتم تقييمها عبر معايير سلوكية بسيطة.
- إشراك المتعلم في التقييم الذاتي، بما يُنمّي لديه الوعي الذاتي والانخراط في تطوير سلوكاته.
تُعتبر “شبكة القيم المدرسية” أداة لمرافقة النمو القيمي، لا للحكم أو العقاب، وهي تُغني التقييم الأكاديمي برؤية شمولية تنظر إلى المتعلم ككُلّ متكامل.
3. إدراج “حقيبة القيم” ضمن أدوات المتعلم
تقترح هذه المبادرة تصميم “حقيبة تربوية” رمزية وفعليّة، تحتوي على:
- كُتيّب صغير يُعرف بالقيم الأساسية التي سيتم التركيز عليها خلال السنة الدراسية.
- دفتر “قيمتي لهذا الشهر” يُدوّن فيه المتعلم نشاطًا واحدًا أنجزه يُجسد فيه قيمة معينة.
- بطاقة “مواقف قيميّة” توزع على المتعلمين كمكافآت معنوية عند تجسيدهم لسلوك قيمي (مثل الاحترام، الصدق، التواضع…).
تهدف هذه الحقيبة إلى جعل القيم ملموسة وقريبة من وجدان المتعلم، وجزءًا من أدواته المدرسية اليومية، تمامًا كما هو الشأن بالنسبة للكتب والكراسات.
V. التقييم والمتابعة
يُعد التقييم إحدى أهم حلقات المنظومة التربوية، وهو ما ينطبق كذلك على التربية على القيم، التي لا يكفي فيها التلقين أو العرض الظرفي، بل تتطلب أدوات لقياس مدى تمثّل المتعلم لها، وتحولها إلى ممارسات سلوكية واقعية. غير أن تقييم القيم لا يمكن أن يُختزل في مقياس عددي أو تقويم معياري، بل يستوجب مقاربة تشاركية، مرنة، وطويلة المدى، تأخذ في الاعتبار البعد الوجداني والسلوكي للمتعلمين.
1. أدوات التقييم المقترحة
يعتمد التقييم القيمي على أدوات متعددة تُراعي الفروق الفردية وتنوّع السياقات التربوية، من بينها:
- الملاحظة السلوكية المنتظمة: يعتمد المدرّس على شبكة ملاحظة تتضمّن مؤشرات سلوكية مرتبطة بالقيم المستهدفة، مثل احترام النظام، روح التعاون، الصدق في التعبير، الالتزام بالأنشطة…
- تقارير المشاريع: يتم تقييم المشاريع البيداغوجية ذات البعد القيمي من خلال تقارير جماعية وفردية تُبرز المهارات القيمية المكتسبة (المشاركة، الإنصات، اتخاذ القرار الجماعي، المبادرة…).
- الروائز القيمية (Questionnaires d’attitudes): وهي أدوات شبه كمية تُستخدم لقياس مواقف المتعلم تجاه قضايا محددة (التسامح، احترام الآخر، الانتماء…)، وتُنجز دوريًا لتتبّع تطوره.

2. التقييم الذاتي للمتعلم
من العناصر التجديدية التي ينبغي إدماجها ضمن عملية التقييم القيمي، ما يُعرف بـ:
- بطاقة التطور الذاتي: وهي وثيقة شخصية يُعبّر فيها المتعلم عن وعيه بسلوكاته القيمية، وما اكتسبه خلال فترة معينة، وما يحتاج إلى تطويره، وذلك من خلال أسئلة موجّهة أو حرّة، مثل:
- ما القيمة التي حاولت تطبيقها هذا الشهر؟
- ما الصعوبات التي واجهتها؟
- كيف ساعدني زملائي أو مدرّسي في ذلك؟
يساهم هذا التقييم الذاتي في تنمية الوعي الداخلي لدى المتعلم، ويُشجّعه على التدرّب على النقد الذاتي، وتحمل مسؤولية نموّه الأخلاقي والسلوكي.
نحو تقييم داعم لا تصنيفي
يجب أن يُبنى التقييم القيمي على منطق الدعم والمرافقة، لا على التصنيف والعقاب. فالقيم تُبنى تدريجيًا، وتتطلب وقتًا وتجريبًا وتكرارًا، ويكون دور التقييم هنا هو تشخيصي وتكويني، يُرافق تطوّر المتعلم ويُشجّعه، لا أن يُصنّفه أو يُقصيه.
خاتمة
تُعد التربية على القيم اليوم أحد أهم الرهانات التربوية في السياق المحلي والدولي، لما لها من دور محوري في بناء الإنسان المتوازن، والمجتمع المتماسك، والدولة الديمقراطية. وفي ضوء التحديات التي تواجهها المدرسة التونسية، من مظاهر عنف، تطرف، ضعف في روح الانتماء، وغياب الثقافة المدنية النشطة، فإن إدماج التربية على القيم كمسار أفقي إجباري لم يعد ترفًا تربويًا، بل ضرورة وطنية ملحّة.
إن الرؤية التي بُسطت في هذا المقال تؤكّد على أهمية الانتقال من منطق الدرس المناسباتي إلى منطق الإدماج الشامل عبر المواد والممارسات والأنشطة، بما يُسهم في تحويل القيم من مجرّد شعارات إلى ممارسات يومية حيّة داخل المدرسة وخارجها.
ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو إلى:
- صياغة سياسة تربوية وطنية واضحة تؤسس لـ “مدرسة مواطِنة” تكون فضاءً فعليًا لبناء القيم، لا مجرّد ناقل للمعارف؛
- اعتماد مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين التربويين والأسريين والمجتمعيين، من أجل ضمان الاتساق في المرجعيات القيمية بين المدرسة والمحيط؛
- بلورة رؤية استراتيجية وطنية للتربية القيمية، تستند إلى المرجعيات الدستورية والتربوية، وتُفعّل عبر برامج تكوين، أدوات تقييم، وإجراءات مؤسساتية ملموسة.
إن التربية على القيم ليست مشروع مادة جديدة، بل مشروع حضاري متكامل، ينشد بناء أجيال حرة، ناقدة، متضامنة، ومسؤولة.
📚 ملاحق (اختياري)
📌 جدول مقترح لإدماج القيم حسب المواد والمستويات
| المادة | المستوى التعليمي | القيمة المستهدفة | النشاط المقترح |
|---|---|---|---|
| العربية | السنة الخامسة | احترام الاختلاف | مناظرة شفوية بين مجموعتين في القسم |
| العلوم | السنة السابعة | الوعي البيئي | مشروع بحث حول تدوير النفايات |
| الرياضيات | السنة السادسة | العدالة والإنصاف | مسألة حول توزيع عادل لميزانية القسم |
| التربية الفنية | السنة التاسعة | التعبير عن الذات | رسم جداري يُعبّر عن قيم التعايش |
📌 استبيان أو شبكة متابعة لمعلمي القيم
شبكة تحتوي على محاور مثل:
- كيف دمجت قيمة معينة في درسك هذا الأسبوع؟
- ما نوع النشاط الذي وظفته؟
- ما مدى تفاعل المتعلمين؟
- هل لاحظت تغيرًا في سلوكهم؟
📖 مراجع مقترحة
- الوثائق الرسمية للبرامج التونسية (خاصة الكفايات العرضية والمجالات القيمية).
- أدبيات اليونسكو حول التربية على القيم، المواطنة العالمية، وثقافة السلام.
- دراسات عربية وأجنبية مثل: