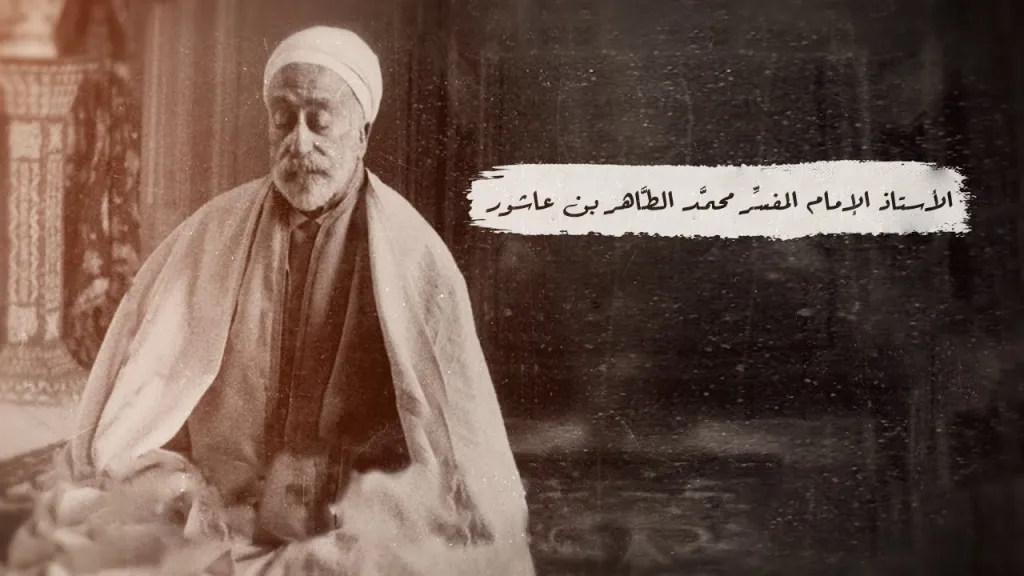Contents
- 1 1. المقدمة: ابن عاشور وإشكالية التغييب التربوي
- 2 2. الإشكالية: لماذا غُيّب ابن عاشور عن المنظومة التربوية؟
- 3 3. السياق التاريخي والسياسي: القطيعة مع التراث الزيتوني
- 4 4. الاختيارات البيداغوجية: الحداثة القطيعية مقارنة الحداثة الجذرية
- 5 5. المقارنة الإقليمية: المفارقة السعودية
- 6 6. المقترحات: كيف نُعيد ابن عاشور إلى المدرسة التونسية؟
- 7 7. الخاتمة: نحو مصالحة بين التراث والحداثة
إعادة الاعتبار لفكر محمد الطاهر بن عاشور في المنظومة التربوية التونسية: دراسة تحليلية نقدية
1. المقدمة: ابن عاشور وإشكالية التغييب التربوي
يُعدّ العلامة محمد الطاهر بن عاشور (1879–1973) أحد أبرز أعلام الفكر الإسلامي الإصلاحي في العصر الحديث، ليس في تونس فحسب، بل في عموم العالم الإسلامي. تميّز فكره بالعمق المقاصدي، والمنهج الأصولي المتجدد، والسعي الحثيث إلى التوفيق بين الثوابت الشرعية ومتطلبات العصر الحديث. ومع ذلك، فإنّ المفارقة الصارخة تكمن في غياب فكره ومؤلفاته عن المناهج التربوية التونسية، رغم قيمته العلمية ومركزيته في تشكيل الهوية الفكرية الوطنية.
تتجاوز هذه الإشكالية مسألة تربوية بحتة لتصبح قضية ثقافية وهُوِيَّة،
إذ يُطرح السؤال: كيف يمكن لنظام تربوي أن يغفل أحد أهم روّاده الفكريين، بينما تحتفي به دول أخرى؟ هذا المقال يتناول إشكالية تغييب فكر ابن عاشور من خلال تحليل السياق التاريخي والسياسي، ودراسة الاختيارات البيداغوجية، وإجراء مقارنة مع تجارب إقليمية، وختامًا تقديم مقترحات عملية لإدماج فكره في المناهج التعليمية.
2. الإشكالية: لماذا غُيّب ابن عاشور عن المنظومة التربوية؟
يُمكن صياغة الإشكالية المركزية للمقال عبر التساؤل التالي:
“لماذا لم يُدرج فكر محمد الطاهر بن عاشور في المنظومة التربوية التونسية، رغم مكانته العلمية ودوره في الفكر الإسلامي الحديث، وفي سياق بناء الهوية الوطنية بعد الاستقلال؟”
وللإجابة عن هذا السؤال، سنعتمد على ثلاثة محاور رئيسية:
- المحور التاريخي والسياسي: كيف تعاملت الدولة التونسية بعد الاستقلال مع التراث الفكري الديني؟
- المحور البيداغوجي: ما طبيعة الاختيارات التربوية التي أدت إلى إقصاء فكر ابن عاشور؟
- المحور المقارن: كيف تعاملت دول أخرى (مثل السعودية) مع فكر ابن عاشور مقارنة بتونس؟
3. السياق التاريخي والسياسي: القطيعة مع التراث الزيتوني
بعد الاستقلال عام 1956، سعت تونس تحت قيادة الحبيب بورقيبة إلى بناء دولة حديثة على النموذج الغربي، مع التركيز على العلمانية والتحرر من الموروث الديني التقليدي. في هذا الإطار، تم تهميش المؤسسات الدينية التقليدية، وعلى رأسها جامعة الزيتونة، التي كانت تمثل مركز الإشعاع الفكري والديني في تونس لقرون.
وقد ارتبط اسم ابن عاشور ارتباطًا وثيقًا بالزيتونة، حيث كان شيخًا لها، وداعيةً للإصلاح الديني القائم على العقلانية والاجتهاد. ورغم أن فكره كان يتقاطع مع بعض أهداف الدولة الحديثة (مثل الدعوة إلى تحرير العقل وتجديد الفقه)، إلا أنه تم إقصاؤه لأن النظام رأى في أيّ مرجعية دينية تهديدًا لمشروعه الحداثي القائم على القطيعة مع الماضي.
نتيجة ذلك:
- طُمس دور رموز الإصلاح الديني، مثل ابن عاشور، في المناهج التعليمية.
- حُوصر الفكر الديني في إطار تقليدي ضيق، دون الاستفادة من تياراته التجديدية.
- فُقدت الصلة بين الهوية الإسلامية والهوية الوطنية الحديثة، مما خلق انفصامًا ثقافيًا.
4. الاختيارات البيداغوجية: الحداثة القطيعية مقارنة الحداثة الجذرية
عند تحليل المناهج التونسية، خاصة في مواد مثل الفلسفة والتربية الإسلامية، نلاحظ سيطرة واضحة للمراجع الغربية (روسو، كانط، ديكارت، نيتشه…) مقابل غياب شبه كامل لأعلام الفكر الإسلامي الحديث، حتى أولئك الذين قدموا رؤى تقدمية.
أمثلة على هذا الخلل:
- يُدرَّس نيتشه وفكره حول “موت الإله”، بينما لا يُذكر ابن عاشور ودعوته لتجديد الفقه الإسلامي.
- تُناقش نظريات العقد الاجتماعي الغربية، بينما يُغفل التراث المقاصدي الإسلامي الذي يربط التشريع بالمصلحة العامة.
هذا النموذج يعكس ما يُمكن تسميته “حداثة قطيعية”، أي حداثة تقوم على نفي التراث بدلًا من تجديده، مما يؤدي إلى:
- انفصام في الهوية: حيث يتلقى المتعلم قيم الحرية والعقلانية من مراجع غربية دون ربطها بجذورها الإسلامية.
- ضعف الوعي النقدي: لأن المتعلم لا يتعرف على المناهج الإسلامية العقلانية التي يمكن أن تشكّل جسرًا بين التراث والحداثة.
5. المقارنة الإقليمية: المفارقة السعودية
من اللافت أن المملكة السعودية، التي تُعتبر معقل الفكر السلفي التقليدي، بدأت في السنوات الأخيرة إدماج فكر ابن عاشور في مناهجها الجامعية، خاصة في كليات الشريعة والقانون. ويُدرس كتابه “مقاصد الشريعة الإسلامية” كمرجع أساسي لفهم الفقه المقاصدي المعاصر.
دلالات هذه المفارقة:
- تُظهر أن فكر ابن عاشور عالمي وليس محليًا، وقابل للتطبيق في سياقات مختلفة.
- تبرز تناقض الموقف التونسي: كيف تُقصي تونس مفكرًا هو من أبنائها، بينما تحتفي به دول أخرى؟
- تؤكد أن الفكر الإصلاحي الإسلامي يمكن أن يكون جسرًا بين المذاهب المختلفة، بدلًا من مصدرًا للصراع.
6. المقترحات: كيف نُعيد ابن عاشور إلى المدرسة التونسية؟
لإعادة الاعتبار لفكر ابن عاشور، نقترح الآتي:
أ. في المناهج الدراسية:
- مادة التربية الإسلامية:
- إدراج نصوص مختارة من “التحرير والتنوير” (تفسير ابن عاشور) لشرح مفاهيم مثل الاجتهاد، المقاصد، العدل.
- مقارنة منهجه التفسيري بالمناهج التقليدية لتوضيح تجديده.
- مادة الفلسفة:
- إضافة نصوص لابن عاشور حول العقل والنقل، ومقارنتها بفلاسفة التنوير.
- مناقشة مفهوم “المصلحة” في فكره مقابل مفهوم “المنفعة” عند بنثام وميل.
- التربية المدنية:
- ربط فكره المقاصدي بمبادئ الدولة المدنية، مثل العدالة الاجتماعية وحرية الاجتهاد.
ب. في تكوين الأساتذة:
- تنظيم دورات تكوينية حول فكر ابن عاشور للمدرسين.
- إعداد أدلة بيداغوجية لشرح منهجه بطريقة مبسطة.
ج. في البحث الأكاديمي:
- تشجيع رسائل الماجستير والدكتوراه حول فكر ابن عاشور.
- عقد ندوات جامعية لتجديد قراءته في ضوء التحديات المعاصرة.
7. الخاتمة: نحو مصالحة بين التراث والحداثة
إهمال فكر ابن عاشور في المنظومة التربوية التونسية ليس مجرد إغفال أكاديمي، بل هو أزمة هوية تعكس انفصالًا عن الجذور الفكرية للبلاد. إن إعادة إدماج فكره ليست دعوة إلى الماضي، بل هي محاولة لبناء حداثة متجذرة في تراثها، قادرة على الحوار مع العالم دون ذوبان أو انغلاق.
الرسالة المركزية:
لا يمكن لتعليم يقطع صلته برموزه الإصلاحية أن يُنتج مواطنين واعين بذواتهم، قادرين على المساهمة في الحضارة الإنسانية من موقع الندية لا التبعية. ابن عاشور ليس تراثًا للماضي، بل هو مشروع مستقبلي لتونس والعالم الإسلامي.
مصادر:
- Google Scholar (https://scholar.google.com) للبحث عن أوراق أكاديمية.
- موقع مؤسسة مؤمنون بلا حدود (https://www.mominoun.com) لأبحاث حول الفكر الإسلامي.
- المكتبة الوطنية التونسية (https://www.bibliotheque.nat.tn) لوثائق تاريخية.
- كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ محمد الطاهر بن عاشور